صحيح أن أحداثا داخلية سرعت إسقاط المالكي، آخرها هزيمته أمام داعش في الموصل، إلا أن الحقيقة تؤكد أن واشنطن بعد أن استنفدت أغراضها منه، تركته يتخبط في سياساته. العرب
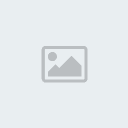
هارون محمد [نُشر في 18/09/2014، العدد: 9683، ص(

] ثبت بما لا يقبل الشك أن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، شخص لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي، ولم يقرأ تاريخ العراق الحديث، ولا يفهم معنى المقولة التي صارت مثلا متداولا (لو دامت لغيرك.. ما وصلت إليك) وتصرف خلال سنوات حكمه على طريقة صبيان الشوارع الذين لا يوقفهم وازع أخلاقي أو رادع اجتماعي، حتى يخيّل للمراقبين السياسيين الذين تابعوا سياساته على مدى أكثر من ثماني سنوات أنه يصعب أن يتحول هذا الكائن الغوغائي إلى إنسان سوي ورجل دولة وسياسة.
وإذا صحت رواية السفير الأميركي الأسبق في بغداد زلماي خليل زاد التي أدلى بها إلى صحيفة “نيويوركر” الأميركية في يونيو الماضي عن كيفية اختياره للمدعو جواد المالكي قبل أن يتحول إلى نوري بديلا لرئيس الحكومة الانتقالية إبراهيم الجعفري، فإن التقييم الموضوعي لهذا الاختيار، يعطي دلالات لا لبس فيها، بأن الأميركان تعمدوا التقاط هذا الشخص المغمور وقدموه من آخر الصفوف إلى المقدمة وفي ذهنهم أشياء كثيرة يندرج بعضها ضمن استمرار مخططهم التدميري للعراق وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتجذير الطائفية وإشاعة الفتنة في هذا البلد الذي لم يشهد فترة سوداء منذ تحريره من الاحتلال الفارسي الكسروي قبل 1400 سنة حتى اليوم، إلا في سنوات المالكي الدموية التي ما تزال آثارها قائمة. ومن يقرأ تاريخ العراق لابد أن يقتنع بأن عهود الاحتلال الهولاكي والبُويهي والسلجوقي والمملوكي والعثماني والإنكليزي، إلى غاية الاحتلال الأميركي وما شهدته من قمع واضطهاد وتنكيل، لا تعادل- مجتمعة- سنوات المحنة التي كان المالكي فيها على رأس السلطة.
يقول زلماي خليل زاد في روايته المثيرة، وهو من اليمين الأميركي وأحد مخططي الحرب على العراق، اختاره الرئيس السابق جورج دبليو بوش مبعوثا له في أعقاب الاحتلال ثم أعاده إلى بغداد سفيرا خلفا للسفير نكروبونتي، إن البيت الأبيض أشعره بضرورة إبعاد الجعفري عن رئاسة الحكومة والحيلولة دون مجيئه مرة ثانية، إضافة إلى أن قيادات شيعية وكردية وسنية- لا يذكر أسماء- تمنّت ذلك أيضا. ويضيف زلماي، وقعت في حيرة خصوصا وأن اجتماعات الائتلاف الوطني (الشيعي) لاختيار رئيس جديد للوزراء تدور في حلقة مفرغة والجعفري وعادل عبدالمهدي يتنافسان بضراوة دون حسم، وكنا- ويقصد الأميركان- نريد أن تنتهي تلك الاجتماعات إلى نتيجة (ديمقراطية) باختيار شخصية مقبولة ولكن دون جدوى، وتحدثت- يقول زلماي- مع زعامات شيعية- لا يفصح عن أسمائها والاعتقاد أنه يقصد السيد السيستاني وعبدالعزيز الحكيم- ودعوتها إلى الإسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد، لتعزيز النهج الديمقراطي لمرحلة ما بعد صدام وإعطاء مصداقية للإدارة الأميركية وشعارها المرفوع وقتئذ تحرير العراق، ولكن بلا نتيجة.
ويستطرد زلماي: وأنا في حيرتي تلك جاءني أحد رؤساء إحدى هيئاتنا الاستخبارية العاملة في العراق، ودس في يدي قصاصة ورق صغيرة، ولما اطلعت على ما فيها قرأت اسم (جواد المالكي) وتذكرته فقد كان نائبا عن حزب الدعوة في الجمعية الوطنية ورئيسا للجنة الأمن والدفاع فيها، وفي اليوم التالي دعوته إلى مأدبة عشاء في بيتي وهمست في أذنه بأنك رئيس الوزراء الجديد و… جهّز حالك!
طبعا لم يذكر زلماي كيف أقنع أقطاب الائتلاف الشيعي بتجاوز الجعفري وعبدالمهدي وكيف سوّق المالكي؟ فهذه من أسرار المهنة لا يجوز للسفراء الأميركيين ذكرها لاعتبارات تتصل بما يسمى مقتضيات المصلحة، وإذا تذكرنا أحداث تلك الفترة، نتوصل إلى جملة حقائق سياسية، أبرزها أن إيران أعطت الضوء الأخضر لاختيار المالكي انسجاما مع الرغبة الأميركية، وتخلت عن الجعفري التي كانت توحي قبل ذلك بأنها تريده ولا تحبّذ مجيء منافسه عادل عبدالمهدي، أما التطور الخطير في هذا الموضوع فإن نواب التيار الصدري، وكان عددهم 31 نائبا، صوتوا للمالكي في خطوة لم تخطر على بال أحد، ولم يقدم قادة التيار تفسيرا مقنعا لحد الآن عن سبب تفضيلهم المالكي على الجعفري الأقرب إليهم، باستثناء ادعاءات لا تنطلي على أحد، خصوصا عندما تكررت الحالة عقب انتخابات 2010 التي جاءت بعد أقل من عامين على «صولة الفرسان» التي نفذ فيها المالكي، بدعم أميركي، حملة مطاردة الصدريين في البصرة.
وللمعلومات، وهذا ما ذكرته عديد الصحف الأميركية عام 2006، فإن الرئيس بوش الابن أصيب بالغثيان عندما اجتمع مع رئيس الحكومة العراقية الانتقالية إبراهيم الجعفري في زيارته لواشنطن التي أهدى فيها سيفا من الذهب، شبيها بسيف الإمام علي، إلى وزير الدفاع رامسفيلد في حادثة بقيت محفورة في الذاكرة الوطنية العراقية. ويُنقل عن بوش أنه لما استقبل الجعفري واجتمع به، خيّل له أنه يلتقي مع شخص من العصور الوسطى، والواضح أن شكل الجعفري الكاريكاتيري وتقاسيم وجهه المتجهم ونظرات عينيه الحائرتين لم يستطع الرئيس الأميركي هضمها، خاصة وأن بوش صاحب مزاج كما هو معروف، فقرر تغييره وأوعز إلى سفيره زلماي بإيجاد بديل.
ووقع الأكراد والسنة العرب المشاركون في العملية السياسية في خطأ سياسي، عندما اعتقدوا أن المالكي سيكون أفضل من الجعفري، الذي تمادى في طائفيته عقب انتخابات 2005 والبدء بتشكيل حكومة جديدة، ووصل إلى ذروة بشاعتها في أحداث تفجير المرقدين العسكريين في شباط 2006 عندما سمح للمليشيات الشيعية باستباحة العاصمة بغداد، واغتيال رجال دين وعلماء وشخصيات سياسية وعسكرية سنية وحرق عشرات المساجد، وحسب ما نسب إليه أنه أبلغ زملاءه في الائتلاف الشيعي بضرورة إعادة اختياره لرئاسة الحكومة لأنه عازم على تنظيف بغداد من السنة العرب خلال فترة قصيرة، وقد شاعت قولته في الأوساط الشعبية السنية والرسمية، وباتت تشكل هاجسا مرعبا، وقال لي طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق إن الجعفري أعطاه ورقة بيضاء بعد أن وضع توقيعه عليها وطلب منه إدراج مطالب السنة العرب مؤكدا له أنه يتعهد بتنفيذها مهما كان حجمها، ويضيف الهاشمي أنه رفض تناول الورقة من الجعفري رغم إلحاحه، لأن ما نسب إليه عن تنظيف بغداد من السنة، كان يطغى على كل شيء وقتئذ.
وجاء نوري المالكي وتربّع على كرسي رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، وكانت أول خطوة خطاها في منصبه الجديد تكريس الطائفية رسميا، وتماهى مع الأميركان في اعتبار أن السنة العرب في العراق كلهم بعثيون وصداميون وزرقاويون وتكفيريون وغيرها من الصفات التي وجدت استجابة لدى إدارة بوش، خصوصا وأنه لم يوافق على وزراء حكومته الأولى إلا بعد مصادقة السفارة الأميركية.
اعتقد الأميركان أن المالكي سهل القيادة ما داموا قد جاءوا به، ومن جانبه استمر طوع إشارتهم يرضخ لهم بلا نقاش، ويلبي طلباتهم بلا تأخير وظل هكذا طيلة دورته الأولى، بل إنه تحمل مسؤولية أحداث خطيرة فُرضت عليه ولم يعْترض عليها، أبرزها إجباره على توقيع قرار إعدام الرئيس صدام حسين نهاية عام 2006 صبيحة عيد الإضحى.
وبهذا الصدد هناك رواية مصدرها جلال طالباني الذي سأله أحد قياديي الحركة الإسلامية الكردية يقال إنه الشيخ علي بابير، كيف سمحت للمالكي بإعدام صدام يوم العيد؟ فرد ضاحكا وهو يقول: (يا مالكي يا بتيخ.. بابا الأميركان قرروا إعدامه واختاروا توقيته)
المالكي تفرعن في دورته الثانية بعد أن سانده الأميركان في الحصول عليها، فأراد أن يستقل بقراراته دون أن يدرك أن أميركا لديها حشد من الخدام (جمع خادم) يحملون عناوين وظيفية مثل رئيس دولة أو حكومة أو وزير أو قائد عسكري أو زعيم حزب، وفي نظرها أن هذا الخادم يظل خادما، ويمكن ترقيته ليصبح رئيس خدام، أما اذا صدّق حاله وأقنع نفسه أنه جاء بذراعه فإن مصيره يكون الطرد من الخدمة ومثال ذلك شاه إيران البهلوي وعيدي أمين وجعفر نميري وعشرات الرؤساء الآخرين، أما إذا عاند وتحدى ولم يخضع لأسياده، فإن الحماية الأميركية ترفع عنه ويصبح إما مقتولا أو طريدا، والحالات من هذا النوع عديدة.
صحيح أن أحداثا داخلية سرّعت إسقاط نوري المالكي، آخرها هزيمته أمام داعش في الموصل، إلا أن الحقيقة تؤكد أن واشنطن، بعد أن استنفدت أغراضها منه، سحبت يدها من دعمه، فسقط صريعا لا يقوى على الحركة والمناورة، وهذا مصير الخدام في كل زمان ومكان.
كاتب سياسي عراقي














 المشاركات
المشاركات نقاط
نقاط التقييم
التقييم











